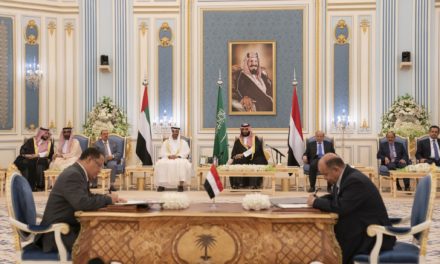كشف الهجوم المدمر الذي وقع قبل أقل من شهرين على منشأتين نفطيتين كبيرتين تابعتين لشركة أرامكو السعودية في المنطقة الشرقية عن مدى ضعف المملكة العربية السعودية أمام التهديدات الأجنبية، فضلا عن عجزها عن الدفاع عن نفسها.
وعلى الرغم من أن الحوثيين أعلنوا مسؤوليتهم عن الهجوم، إلا أن المسؤولين السعوديين والأمريكيين ألقوا باللوم على إيران. وأثار الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” الكثير من الغضب السعودي بسبب رد فعله على الهجوم. وشعر السعوديون بخيبة الأمل عدم رغبة أقرب حليف لهم في الرد بقوة أكبر، واستسلم المسؤولون السعوديون أمام عدم قدرتهم على تحمل الموقف وحدهم. وحث الملك “سلمان”، الذي اتهم الحوثيين المدعومين من إيران بإطلاق نحو 600 طائرة بدون طيار وصاروخ باليستي على المملكة في الأعوام الأخيرة، المجتمع الدولي على وقف العدوان الإيراني. ويجد السعوديون أنفسهم الآن في موقف لا يحسدون عليه؛ فبعد عقود من الاعتماد على الشركاء المحليين والأجانب لتوفير الأمن السياسي والإقليمي، يتعين عليهم الآن استخدام مواردهم الخاصة لدرء التهديدات المتزايدة التي يواجهونها في الشرق الأوسط.
أصل المعضلة
وتأتي أوجه القصور في السعودية فيما يتعلق بالدفاع نتيجة لقرون من سوء التخطيط الدفاعي والافتقار للرؤية. وكان الصعود الأول للدولة السعودية في عام 1744 بفضل التحالف بين “محمد بن سعود” و”محمد بن عبد الوهاب”، مؤسس الحركة الوهابية المتشددة دينيا. لكن العثمانيين الذين نظروا بحذر تجاه هذا التحالف الناشيء طلبوا من حلفائهم في مصر وضع حد للتهديدات الإقليمية والأيديولوجية الناشئة في الجزيرة العربية. وفي عام 1818، غزا جيش “إبراهيم باشا” الدولة السعودية وقام بتدمير عاصمتها.
وفي حين كان لدى الدولة السعودية الثانية، التي أسسها “تركي بن عبد الله” عام 1824، طموحات إقليمية متواضعة، فإنها ظلت عاجزة بسبب الخلافات الداخلية. وفي عام 1891، أسقطت أسرة “آل رشيد”، الموالية للعثمانيين، الدولة السعودية الجديدة في معركة “المليداء”. ورتب العثمانيون انتقال الحاكم المخلوع “عبد الرحمن آل سعود” إلى الكويت، على أمل أن يتمكنوا من إبقائه تحت جناحهم، وهي خطوة لم يعارضها البريطانيون، لأنهم اعتقدوا أنه قد يكون مفيدا في خططهم للجزيرة العربية. ولاحقا، استولى ابنه النشط “عبد العزيز”، الملقب بـ “ابن سعود”، على الرياض عام 1902، ومهد الطريق لظهور الدولة السعودية الثالثة التي نعرفها اليوم عام 1932 وحكمها حتى وفاته عام 1953.
ومن أجل تجنب مواجهة نفس مصير الدولتين السعوديتين الأولى والثانية، فهم “ابن سعود” أنه بحاجة إلى دعم قوة أجنبية متفوقة على الإمبراطورية العثمانية. وقد فهم أيضا أنه إذا أراد تحقيق أهدافه الإقليمية، فسوف يحتاج إلى قوة عسكرية قوية لتحل محل المقاتلين القبليين غير الجديرين بالثقة. وفي عام 1912، شكل “ابن سعود” قوة عسكرية وهابية تدعى “الإخوان”. وقد أثبتت هذه القوة فعاليتها في تمكينه من نشر سيطرته على أربعة أخماس شبه الجزيرة العربية، من الخليج العربي إلى البحر الأحمر، ومن العراق الذي تسيطر عليه بريطانيا إلى جازان ونجران في الجنوب.
وبفضل الدعم العسكري والمالي البريطاني، استولى “الإخوان” على المنطقة الشرقية، ووسّع “ابن سعود” إمارته إلى خارج “نجد”. ومع استشعاره بالزوال الوشيك للإمبراطورية العثمانية، راهن “”ابن سعود” على القوة البريطانية، ووقع معاهدة “دارين” مع المملكة المتحدة عام 1915. وبالإضافة إلى توفير موارد مادية إضافية لتلبية طموحات “ابن سعود”، جعلت المعاهدة دولته المزدهرة محمية بريطانية.
وخلقت هزيمة الإمبراطورية العثمانية في الحرب العالمية الأولى، وفقدانها للأراضي العربية غرب آسيا، فرصا وتحديات لكل من البريطانيين و”ابن سعود”. وعززت بريطانيا قبضتها على المشيخات العربية الصغيرة في الخليج العربي، بالإضافة إلى استيلائها على العراق وفلسطين. لكن غارات الإخوان المتكررة على المواقع الدينية الشيعية العراقية في النجف وكربلاء تسببت في مشاكل أمنية خطيرة للبريطانيين، الذين وقعوا تحت ضغط من الشريف “الحسين بن علي”، ملك الحجاز، للوفاء بوعدهم بإنشاء مملكة عربية في غرب آسيا . ونتيجة لذلك، اتفق البريطانيون مع “ابن سعود”، خلال معاهدة “العقير” عام 1922، على منع “الإخوان” من الدخول إلى العراق وعبر الأردن، مقابل منح البريطانيين الموافقة الضمنية لابن سعود على غزو الحجاز.
وعلى عكس “الشريف حسين”، الذي كانت لديه تطلعات إقليمية أكثر طموحا وراء شبه الجزيرة العربية، لم يكن لدى “ابن سعود” رغبة في نشر مملكته خارج شبه الجزيرة العربية، وقبل الشروط البريطانية للبقاء خارج الكويت وقطر والبحرين والإمارات المتصالحة (الإمارات العربية المتحدة اليوم) وعمان واليمن. وقبل اكتمال مملكته، اقترح “ابن سعود” عام 1930 توقيع معاهدة صداقة مع إيران. وقد أهانه “رضا شاه بهلوي”، الذي لم يرغب في تطوير علاقة خاصة بين البلدين، برفض الاقتراح.
ولم يحب “ابن سعود” البريطانيين، على الرغم من أنهم سهلوا إنشاء مملكته. واعتبر التزامهم تجاه السعوديين غامضا وسائلا، واستاء من رفضهم الاستثمار في صناعة النفط الواعدة في المملكة. وفضل العاهل السعودي العمل مع الأمريكيين، الذين بدوا كرماء وودودين ومستعدين لتحمل مخاطر محسوبة. وفي عام 1933، وقع “ابن سعود” صفقة مع شركة “ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا”، التي استخرجت النفط في نهاية المطاف من المملكة عام 1938. وقد مهد هذا الاكتشاف الهائل الطريق لاجتماع تاريخي عقد عام 1945 بين الرئيس الأمريكي “فرانكلين روزفلت” و”ابن سعود” على متن سفينة “يو إس إس كوينسي” الأمريكية. وأظهرت التطورات اللاحقة في الشرق الأوسط أن الزعيمين كان لديهما توقعات مختلفة من اجتماعهما التاريخي. وكان تركيز “روزفلت” على اكتشافات المملكة المذهلة من الهيدروكربون، وإنشاء دولة يهودية في فلسطين. وكان “ابن سعود”، في الوقت نفسه، يأمل في أن تدافع الولايات المتحدة عن السعودية دون قيد أو شرط ضد التهديدات الأجنبية، في مقابل الشراكة في مشاريع النفط.
لكن عدم رغبة الولايات المتحدة في الانضمام إلى المملكة في نزاعها مع القبائل المدعومة من بريطانيا في سلطنة عمان والإمارات على “واحة البريمي” في أوائل الخمسينيات، واعترافها عام 1962 بالنظام الجمهوري في اليمن، أثار غضب العائلة المالكة السعودية. ولقد شعروا بخيبة أمل تجاه واشنطن خاصة بعد أن امتنع الرئيس “جون إف كينيدي” عن اتخاذ أي إجراء ضد غارات القوات الجوية المصرية على مدينتي نجران وجيزان السعوديتين، باستثناء بعض الرحلات الجوية الرمزية للقوات الجوية الأمريكية فوق الرياض وجدة. وكانت السعودية تشعر بالتهديد بالفعل بسبب تصاعد القومية العربية وصعود الأحزاب السياسية اليسارية، لذا فإنها اعتمدت سياسة إقليمية هدفت بالأساس إلى عزل نفسها عن تداعيات هذه الأيديولوجيات الناشئة.
فشل سياسة الموازنة الإقليمية
وفي خمسينيات القرن الماضي، خشي أفراد العائلة المالكة السعودية من أن تتحول “أرامكو” إلى مرتع للانتماءات السياسية اليسارية والقومية العربية. وعلى الرغم من تقديرهم لإسهامها الهائل في اقتصاد البلاد، فقد أدركوا أن أرامكو تعمل كشركة نفط وتجمع ثقافي في الوقت نفسه. وقد لعب الآلاف من العمال العرب المسيسين، معظمهم من الفلسطينيين والسوريين والسودانيين والبحرينيين، دورا حاسما في حشد زملائهم من العمال السعوديين للأحزاب السياسية والحركات العمالية. وقد تصادم هذا التهديد الليبرالي الداخلي مع الطبيعة الوراثية والمتحفظة للغاية للسياسة السعودية.
واعتمد الملوك السعوديون منذ بداية حكم “سعود بن عبد العزيز” عام 1953، الابن الأول لـ”عبد العزيز بن سعود”، وحتى وفاة الملك “عبد الله” عام 2015، سياسة وقائية بشأن التدخل في الشؤون البينية العربية. وكانت هذه السياسة تهدف الأساس إلى تحييد الأيديولوجيات اليسارية والقومية ومنع مصر والعراق من السيطرة على العالم العربي. وهكذا، عارضت المملكة العربية السعودية، إلى جانب مصر، حلف بغداد، وهو تحالف عسكري تم إنشاؤه عام 1955 بين عدة دول في الشرق الأوسط مع المملكة المتحدة، لأنه كان سيزيد من نفوذ العراق بين دول المنطقة. وقد انسحبت بغداد من الاتفاقية في نهاية المطاف بعد انقلاب الجمهوريين عام 1958.
وحول السعوديون قلقهم إلى مصر بعد اندماجها خلال العام نفسه مع سوريا لتشكيل “الجمهورية العربية المتحدة”. حتى أن السعوديين حاولوا اغتيال الرئيس “جمال عبد الناصر”، الذي صعد ليصبح بطل العالم العربي بلا منازع. ولكن بعد مرور عام على حل “الجمهورية المتحدة” عام 1961، وقع انقلاب جمهوري في اليمن، وناشد قادته “ناصر” لإرسال قوات لتعزيز سيطرتهم على البلاد. وأثار تمركز الجيش المصري في اليمن، بجانب الحدود الجنوبية للسعودية، وانشقاق العديد من طياري سلاح الجو السعودي إلى مصر، بما في ذلك قائد القوات الجوية، صدمةً وخوفا داخل العائلة المالكة السعودية.
لكن حرب “الأيام الستة” عام 1967، التي فازت فيها (إسرائيل) فوزا ساحقا ضد الجيوش العربية المشتركة لمصر وسوريا والأردن، أدت إلى انسحاب الجيش المصري من اليمن بحلول نهاية العام. ولمدة عقد من الزمان، عملت النخبة السعودية الحاكمة على التأكد من عدم وجود تهديدات أجنبية لاستقرار المملكة. وفي الوقت نفسه، تدخل النظام بسرغة لقمع حركات المعارضة الداخلية التي هددت بإسقاط الدولة السعودية الثالثة. وتعد أبرز الأمثلة على هذا المعارضة هي حركة الأمراء الأحرار في الستينيات، بقيادة الأمير “طلال بن عبد العزيز”، الذي طالب بتحويل المملكة العربية السعودية إلى ملكية دستورية، إضافة إلى محاولة انقلاب ضباط الطيران في عام 1969، وصولا إلى حادثة اغتيال الملك “فيصل” عام 1975، وواقعة الاستيلاء على المسجد الحرام في مكة عام 1979 من قبل السلفيين المحافظين، وليس انتهاء بالتمرد الشيعي في المنطقة الشرقية الغنية بالنفط.
ومع صعود الجمهورية الإسلامية في إيران عام 1979، مع هدفها العدواني المتمثل في تصدير ثورتها إلى العالم العربي، دخلت العراق والسعودية إلى قلب السياسة الخارجية لآية الله الخميني. وبدلا من إنشاء تحالف عسكري عربي موحد لردع إيران، دفع السعوديون العراق لشن حرب ضدها. وبعد مرور عام على هذا المستنقع المدمر، اتخذ السعوديون زمام المبادرة في إنشاء “مجلس التعاون الخليجي”، الذي انضمت إليه الدول العربية الصغيرة في الخليج على مضض، على الرغم من مخاوفها من الهيمنة السعودية. ويشير استبعاد العراق من مجلس التعاون الخليجي إلى أن السعوديين كانوا يخشون النظام البعثي في بغداد بقدر ما يخشون الجمهورية الإسلامية في طهران. وفشل مجلس التعاون الخليجي في إنشاء قوة عسكرية قادرة على ردع التهديدات الأجنبية. وعلى الرغم من تخصيص أموالا فلكية للتسلح، بقيت القوات المسلحة السعودية “نمرا من ورق” في أحسن الأحوال.
وأظهر أفراد العائلة المالكة السعودية على مر السنين افتقارا للقدرة على التحليل العميق للأوضاع من حولهم. وفي حين أنهم دفعوا العراق لخوض الحرب ضد إيران في الثمانينات، فإنهم فشلوا في استخدام نفوذهم لمنع الغزو العراقي للكويت عام 1990، قبل أن يفتحوا بلادهم للقوات الأمريكية لاستعادة استقلال الكويت. ومباشرة بعد نهاية حرب الخليج عام 1991، التزمت مصر وسوريا في إعلان دمشق بالحفاظ على السلامة الإقليمية للدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، لكن السعودية رفضت عرض الحماية المصري السوري وأعلنت عدم رغبتها في استضافة القوات العربية على أراضيها لفترة طويلة.
وعندما تحولت الانتفاضة السورية عام 2011 إلى حرب أهلية، كانت السعودية تأمل في أن تؤدي إلى سقوط النظام الموالي لإيران في دمشق. وفي عام 2013، شاركت في مركز العمليات العسكرية بقيادة الولايات المتحدة، الذي قام بتسليح جماعات المعارضة السورية العاملة في جنوب غرب سوريا. ومع ذلك، تركزت الدوافع الأساسية للمشاركين الآخرين في التحالف، بما في ذلك الولايات المتحدة والأردن والإمارات العربية المتحدة، على هزيمة المتمردين الإسلاميين وليس نظام “بشار الأسد”. لذلك، لعب التحالف دورا حاسما في انهيار الجبهة الجنوبية المعارضة المدعومة من السعودية.
وغالبا ما حاصرت النتائج الكارثية للقرارات السعودية – التي افتقرت إلى الفهم الدقيق لعوامل السياسة الخارجية – صناع القرار السعوديين. وفي الواقع، كان قرارهم بخوض الحرب في اليمن أكثر كارثية من عملياتهم في سوريا. ولقد أثبت اليمن أنه كان مستعصيا على العديد من القوى الأجنبية في الماضي، ولم تكن السعودية استثناء. ولم تتمكن المملكة من تكوين جيش مؤهل للقتال منذ أن سمحت الأسلحة البريطانية الحديثة لـ “ابن سعود” بهزيمة محاربي الصحراء من “الإخوان” في معركة “السبلة” عام 1929.
في الأخير، لقد تسبب ضعف المملكة العسكري، وكراهيتها المبطنة للأجانب، وسلوكها الدبلوماسي الفاسد مع جيرانها، بمنعها من تثبيت نفسها كقوة إقليمية مهيمنة، وليس هذا فحسب؛ بل إن ذلك صار يهدد اليوم بقاء البلاد على المدى الطويل.